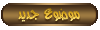تجربة قرآنية تاريخية في قضية الزعامة هي قصة طالوت، التي عقَّب القرآن عليها بقوله - سبحانه -: (تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْـحَقِّ وَإنَّكَ لَـمِنَ الْـمُرْسَلِينَ) [البقرة: 252]؛ لنفهمها درساً منهجياً باقياً لأتباع المرسلين.
البداية هي تفسير حقيقة الموت والحياة:
إن الاستعداد للموت أساس الفهم الصحيح والحركة الصحيحة، ولذلك تبدأ الآيات بمعالجة هذا الإحساس بحقيقة أن الحرص على الحياة لا يبقيها، وأن الخوف من الموت لا يمنعه، وهذه هي الحقيقة في المعالجة القرآنية (أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْـمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا) [البقرة: 243]، فقد أماتهم الله وهم حريصون على الحياة، وبعد أن ماتوا وفقدوها أحياهم الله.
وبعد فهم قضية الموت والحياة يكون القتال في سبيل الله أمراً سهلاً: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 244].
وعندما يكون الاستعداد للموت يكون الاستعداد للبذل سُنَّةً نفسيةً ثابتةً ومعياراً سلوكياً صحيحاً: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة: 245].
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)[البقرة: 246].
تبدأ الآيات بالتحديد الزمني للتجربة.. (ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى)، وهذا التحديد الزمني كان ضرورياً؛ لأن آية الملك ستكون بقية مما ترك آل موسى وآل هارون.
ولكن الأمر يتطلب الاطمئنان إلى مصداقية هذا الطلب (قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا)[البقرة: 246].
ولكن أصحاب الطلب يثبتون أهميته (قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا) [البقرة: 246].
وهي إجابة مقنعة؛ فعندما يكون الإخراج من الديار والأبناء لا بد أن يكون القتال. فلما كتب عليهم القتال بعد مطالبتهم به لم يواصلوا الطريق الواجب: (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ? وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [البقرة: 246].
لذلك؛ فإن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول؛ فإن أكثر بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابةً لطلبهم.
(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا) [البقرة: 247]، وكلمة (بَعَثَ) تدل على أن نشأة الإمارة في مثل هذا الواقع قضية قدرية خالصة؛ لأن المعايير اللازمة للإمارة غير قائمة في واقع الفراغ، وهذا لا يعني إلا اللجوء إلى الله والاستعانة به في أن يبعث من تجتمع حوله القلوب، بدلاً من الهروب وإسقاط واجب الجماعة والاتجاه نحو العزلة.
كما أن كلمة (بَعَثَ) تدل على أن الزعامة في مثل هذه الظروف ارتفاع بمستوى شخصِ مَنْ قدَّرها الله له فوق انحطاط الواقع والخروج به عن سياق الضعف والتخبُّط.
(قَالُوا أَنَّى? يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ) [البقرة: 247]. وبمجرد بعث طالوت؛ بدأت مشكلة الصراع على الزعامة. وقد يتبادر إلى الذهن أنه ما كان لهذه المشكلة أن تظهر في مثل هذه الظروف، ولكن هذه المشكلة تفرض نفسها على كل الظروف، وتلك هي خطورتها، وهو ما يقتضي التعامل معها باعتبار تلك الخطورة. وجميعهم قالوا.. كل واحد منهم قال.. كل واحد منهم كان يتصور أنه أحقُّ بالزعامة. وفَهْمُ هذه المشكلة هو الذي يحقق التعامل الصحيح معها، وَفْقاً لعدة قواعد:
أولاً: فرض الزعامة بوصفها أمراً واقعاً (قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ) [البقرة: 247].
ثانياً: تحقيق القناعة النفسية بالزعامة بعد فرضها. وترتيب الآية في تفسير المشكلة هو نفسه ترتيب مواجهتها: الفرض، ثم القناعة.
ثالثاً: إثبات إمكانية الزعامة المفروضة هو أول أسباب تحقيق القناعة (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) [البقرة: 247] وهما عنصرا الزعامة؛ فالناس يحتاجون إلى العلم الصحيح، ويحتاجون إلى صاحبه وتكون له الولاية عليهم. وكذلك يحتاج الناس إلى العمل، ويحتاجون إلى صــاحب القــدرة عليــه. ولا يؤثر في الأتباع ويضمن ولاءهم إلا العطاء العلمي والقدرة العملية. العطاء العلمي الذي يجده الأتباع في زعيمهم فيتحقق لهم الإيمان بأنهم على الحق في كل موقف وفي كل خطوة. والقدرة العملية في تحريكهم إلى العمل بمقتضى هذا الحق.
وبتحقيق الولاء للزعامة السياسية بخصائصها وقدراتها الذاتية والنفسية والسلوكية في شخص الزعيم.. ينقطع طمع كل واحد فيها؛ لتبدأ مرحلة تقييم هذه الزعامة التي فرضت عليهم.
(وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 247]. إن الإيمان بأن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء؛ هو الأساس النفسي الذي تتحقق به المعالجة. وهذا الترتيب له تفسيره:
فالأمر الأول: هو فرض الزعامة الذي سينهي الطمع فيها؛ لتنتقل النفس بعد اليأس منها إلى تقييم من استحقها دون الآخرين.
الأمر الثاني: هو الإمكانات؛ فهي واقع ثابت في الزعيم المختار يصعب على الإنسان ادِّعاءه لنفسه؛ ليأتي الاختصاص الذي لا حيلة لأحد فيه وهو المشيئة الإلهية.
واعتبار الكفاءة في اختيار الزعامة يعني أن القدرة على تحقيق الهدف الإسلامي هو المعيار الأساسي للاختيار، وأن المقارنة بين أصحاب الفكر النظري وأصحاب القدرة على تحقيق الهدف الإسلامي الصحيح عملياً يجب أن تكون لصالح أصحاب هذه القدرة العملية.
(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى? وَآلُ هَارُونَ) [البقـــرة: 248]. وكـــل ما سبق قد لا يكفي النفس للتسليم بالزعامة؛ فيدخل إلى النفس أن كل هذه الاختصاصات غير كافية إذا كان الأمر متعلقاً بمصير الأمة؛ فترغب النفس بعد ذلك إلى الاطمئنان إلى صواب الزعامة، وإمكانية تحقيق النصر بها؛ فتنتقل الآيات إلى متابعة المشكلة.
إن التابوت حقيقة محسوسة ملموسة للاطمئنان. والتابوت نفسه جعل الله فيه السكينة، وكان التابوت كافياً.. ولكن طالوت أتى بالتابوت ليكون الارتباط القدري الشخصي بين نبي الأمة ونصرها هو ما تعنيه البقية (وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى? وَآلُ هَارُونَ) [البقرة: 248].
ويبين لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقيقة هذا الارتباط باعتبار أن امتداد صلة الأمة بالنبي هو أساس الفتح فيقول: «يأتي على الناس زمان يغزون؛ فيقال: فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم! فيفتح عليهم، ثم يغزون؛ فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم! فيفتح لهم»[رواه البخاري في صحيحه].
وفي رواية أبي داود: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يأتي على الناس زمان؛ فيغزو فئام من الناس؛ فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون: نعم! فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم! فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس؛ فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله؟ ويقولون: نعم! فيفتح لهم)).
ولعلَّنا نلاحظ عبارة (هل فيكم من رأى رسول الله؟) التي تدل على أن رؤية رسول الله كانت أساساً للفتح، ومن هنا قدَّم البخاري من خلال أبواب كتاب: الجهاد؛ صورة وصفية لكل تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكأننا نراه؛ ليقترب المسلمون من رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليتحقق في المسلمين أمر يعينهم على فتح الله لهم.
وإن كانت البقية التي تركها آل موسى وآل هارون هي التابوت فيه السكينة من الله؛ فإن ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو كتاب الله وسنته ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله، وسنتي)).
(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ) [البقرة: 249]. لم يكن هناك فارق زمني بين اختيار طالوت زعيماً وبين فصله بالجنود، ولذلك لم تذكــر الآيــة إعلان اتفاق الأتباع على زعامة طالوت، بل جاء مباشرة الفصل بالجنود - الخروج بهــم إلى القتال - فإنَّ أخطر ما يواجه الزعامة أن يعيش الأتباع في فراغ من العمل ولو لوقت ضئيل، وأخطر مشاكل الدعوة هو جمع الأتباع دون وجود الخطط المتفق عليها للعمل. ولا بد من تطور العمل؛ لأن الأتباع لا يقنعون إلا بالعمل، ولا يقنعون بعد العمل إلا بعمل أقوى منه.
(قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) [البقرة: 249]. فالابتلاء بالنهر جاء بعد الفصل بالجنود، وهنا يتبين الفهم الصحيح لمرحلة التربية.. أن تكون من خلال الواقع وفي إطار المواجهة والواقع القتالي، وفي هذا الواقع يكون البلاء.
وتأتي حقيقة التوازن بين الصبر على البلاء، والثبات على الحق والطاعة؛ وبين اعتبار الطبيعة البشرية، فكان مقتضى الصبر على الطاعة هو (فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) [البقرة: 249]. وكان اعتبار الطبيعة هو (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ) [البقرة: 249]. فيدخل في تحقيق التوازن في التربية العدل بين الأتباع؛ لأن الاحتياج إلى الماء سيكون بقدر حجم الجسم، ومعيار حجم الجسم هو حجم اليد، ولذلك كان الأمر بالشرب بغرفة اليد وهو ما جاء في نصِّ الأمر (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ) [البقرة: 249].
ولما كان البلاء هنا هو اختبار الاستعداد للموت؛ كانت طبيعة البلاء من جنس طبيعة الهدف منه، فكان الامتناع عن شرب الماء وهو سبب الحياة؛ اختباراً في القدرة على التضحية بهذه الحياة.
(فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ) [البقرة: 249]. وفي ذلك يقول سيد قطب: "شربوا وارتووا؛ فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده، تبلُّ الظمأ ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف، وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم. انفصلوا عنه؛ لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة. والجيوش ليست بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الصامد، والإرادة الجازمة، والإيمان الثابت المستقيم على الطريق".
(فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) [البقرة: 249]. وهذه الآية تناقش أخطر قضايا فقه الدعوة؛ فالذين آمنوا هنا لا تعني كفر من عصى وشرب، لكنها تعني إيمان من أطاع. وهذا هو حدُّ الارتباط بين مصطلح الإيمان وعلاقته بالواقع العملي للدعوة والسمع والطاعة فيها.. أن تكون الطاعة إيماناً دون التكفير بالمعصية، إلا أن تكون المعصية نفسها كفراً. ورغم الطاعة قد يكون الضعف؛ فالطاعة والإيمان يكون معهما معالجة الطبيعة البشرية الضعيفة.
(قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) [البقرة: 249]. والمتكلمون هنا هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر والابتلاء به، والذين ثبت استعدادهم للموت. إنهم لم يصطدموا بالحرص على الحياة، ولكنهم اصطدموا بواقع المواجهة الصعب: نحن مستعدون للموت ولكننا قلة. وتجاوز هذه الظروف يتطلب مستوى أعلى من تجاوز الابتلاء بالنهر. وهنا يظهر أهل النصر عندما يرتفعون بإيمانهم فوق الظروف. مستوى اليقين بلقاء الله الذي تعرج به النفس فوق مستوى الواقع.
(قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ? وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) [البقرة: 249]. لم يصل إلى مرحلة القدرة على القتال إلا من تجاوز مشكلة الزعامة، ثم بلاء النهر، ثم بلاء الصدام ولقاء العدو. لقد تجاوزوا ذلك بالتجرُّد من حظ النفس وحب الإمارة؛ وهو أشد حظوظ النفس، والتحكم في الرغبة النفسية الطبيعية في الحياة؛ وهو أشد رغبات النفس، والإقبال على الموت؛ وهو أشد مكروه إلى النفس.
وبهذا التجرُّد يتحقق اليقين في لقاء الله.
(وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ) [البقرة: 251]. وبعد إنشاء الواقع العلمي بأبعاده الكاملة؛ تنشأ معايير الاختيار الشرعية والعملية بصورة طبيعية، والمثال عليها اختيار داود - عليه السلام -، وذلك أن داود كان فرداً ضمن الذين كانوا مع طالوت، وكان له دور متقدم بين الصفوة مكَّنه من أن يقتل جالوت، فتميز داود بصورة لم تجعل له قريناً، فكان هو الملك بعد طالوت بصورة تلقائية.
وقَتْلُ داود لجالوت هو اختصار لمعنى التجربة كله، وهذا الاختصار مثال منهجي لحقيقة الصراع كما أراده الله، فقَتْلُ داود الفتى الصغير لجالوت ملك العماليق يدل على قدرة الله المطلقة، ولذلك يقول سيد قطب: "وداود كان فتى صغيراً من بني إسرائيل. وجالوت كان ملكاً قوياً وقائداً مخوفاً.. ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها، إنما تجري بحقائقها. وحقائقها يعلمها هو، ومقاديرها في يده وحده، فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم، ويفوا الله بعهدهم، ثــم يكــون ما يريده الله بالشكل الذي يريده. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير؛ ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم.. وكانت هناك حكمة أخرى مُغَيَّبة يريدها الله؛ فلقد قدَّر أن يكون داود هو الذي يتسلَّم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليمان، فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل؛ جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود.
ونمضي مع القصة؛ فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاء، وتستمد قوتها كلها من إذن الله، وتستمد يقينها كله من الثقة في الله، وأنه مع الصابرين.. إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة الثابتة التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوته، مع ضعفها وقلتها.. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة، بعد أن تجدِّد عهدها مع الله، وتتجه بقلوبها إليه، وتطلب النصر منه وحده، وهي تواجه الهول الرهيب (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿250﴾ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ) [البقرة: 250-251].. هكذا (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) [البقرة: 250] وهو تعبير يصوِّر مشهد الصبر فيضاً من الله يفرغه عليهم فيغمرهم، وينسكب عليهم سكينة وطمــأنينة واحتمــالاً للهــول والمشقــة. (وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا) فهي في يده - سبحانه - يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تميد (وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).. فقد وضح الموقف: إيمان تجاه كفر، وحق إزاء باطل، ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافــرين، فلا تَلَجْلُجَ في الضمير، ولا غبش في التصور، ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق. وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها: (فَهَزَمُوهُم بِإذْنِ اللَّهِ).. ويؤكد النص هذه الحقيقة: (بِإذْنِ اللَّهِ).. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً، وليتضــح التصــور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون، ولطبيعة القوة التي تُجريه.
إن المؤمنين ستار القدرة يفعل الله بهم ما يريد، وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس لهم من الأمر شيء، ولا حول لهم ولا قوة، ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته، فيكون منهم ما يريده بإذنه.. وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين.. إنه عبد الله. اختاره الله".
أما العبرة الكلية من القصة ففيها يقول سيد قطب: "العبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف، ومن تخلِّي القوم عنها فوجاً بعد فــوج في مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله - فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جداً.. فقد كان فيها النصر والعز والتمكين، بعد الهزيمة المنكرة، والمهانة الفاضحة، والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلِّطين".
(تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْـحَقِّ وَإنَّكَ لَـمِنَ الْـمُرْسَلِينَ) [البقرة: 252]، إنها تجربة قرآنية في قضية الزعامة، تقدم درساً منهجياً باقياً لأتباع المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين
م/ن
 أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
 أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا



 الإهداءات
الإهداءات